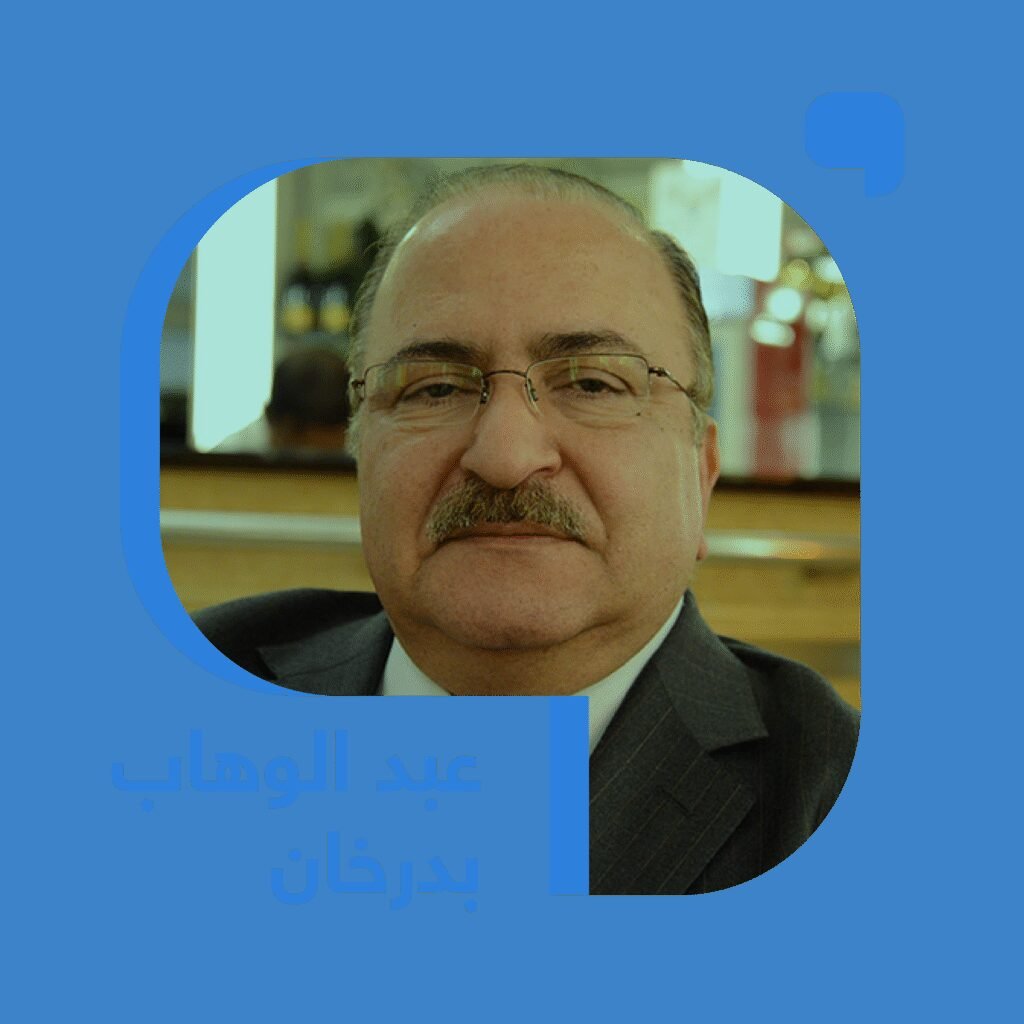
وإذا كانت «خطة ترمب» وضغوطه ومصالحه فرضت على إسرائيل إنهاء الحرب، فإن الدول العربية والإسلامية وكذلك الأوروبية لا تخفي استياءها من غموض «الخطة» وقصورها، إذ تفتقد «الأفق السياسي» المطلوب إذا كانت تهدف فعلاً إلى «سلام مستقبلي» في الشرق الأوسط. لعل أبلغ دليل أن السياسات الرئيسية لواشنطن وإسرائيل لم تخرج وليس متوقعاً أن تخرج من المربع الذي قبعت فيه خلال عامين كاملين، وطوال عقود سابقة. كان يمكن لخطاب ترمب في الكنيست أن يكون رؤيوياً، بدل أن يغرق في الثرثرة تهرّباً من تحديد الأسس المهمة لبناء السلام. أما الإسرائيليون الذين حرص ترمب على دغدغة مشاعرهم، فكانوا ولا يزالون مسكونين بالهواجس الانتقامية، فقط لأنهم لم يحصلوا على «النصر» الذي يعني لهم ألا يبقى أي فلسطيني في فلسطين، أكان ينتمي لـ«حماس» أو لسواها.
لدى الوسطاء غير الأمريكيين شكوك في جدّية التزام «اتفاق غزّة» من جانب إسرائيل، إذ إنها لم تتأخر في ارتكاب عشرات الخروقات الدموية غير المبرّرة، والذريعة هي أن فلسطينيين عاديين وغير مسلحين أرادوا تفقّد بيوتهم وراء الخط الأصفر. ما يدعم هذه الشكوك أن حتى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن أنه يتعين أن تمارس واشنطن «ضغطاً دائماً» لتأمين الاستقرار في قطاع غزة، وهو يزور إسرائيل اليوم مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. أصبحت الإدارة الأمريكية معنيةً الآن بنجاح مسعى رئيسها، لكن خطة الرئيس تحمل كل الألغام الكفيلة بتفجيرها:
1) تجاهل «فلسطين» و«حلّ الدولتين» وعدم تأكيد الصلة بين قطاع غزّة والضفة الغربية من شأنهما أن يضعفا حماس الدول التي دعمت «خطة ترمب»، بمقدار ما أنها تحفّز الإسرائيليين على المضي في «تقسيم» الضفة إلى مناطق تمهيداً لـ «ضمّ» أجزاء منها بحكم الأمر الواقع.
2) مشكلة الأمن داخل غزّة بعد انتهاء الحرب معروفة، لكن تعجّل إسرائيل بتحريك ميليشيات أنشأتها من بعض عصابات التهريب هدّد بمجازر أهلية، ما اضطرّ الجانب الأمريكي لمنح «حماس» غطاءً لضبط الوضع، ما أوقعه في تناقض، طالما أن «الخطّة» تقضي بـ«نزع سلاح» الحركة.
3) الاعتماد على «أمن حماس» لفترة طويلة يزيد من تعقيدات نزع سلاحها وتفكيك حكمها، ما ينعكس على مشاركة الدول في تطبيق مجمل «الخطة»، وأساساً يعاني تشكيل «قوة الاستقرار الدولية» صعوباتٍ بسبب عدم وضوح مرجعيتها وصلاحياتها وطبيعة عملها.
4) «مجلس السلام» يُفترض أن يوحي بالثقة لأنه برئاسة ترمب الذي رشح الرئيس المصري لعضويته، غير أن هذه العضوية قد تشمل إسرائيليين معروفين أو مموهين، كما أن دولاً أوروبية تنظر بارتياب إلى هذا المجلس، تحديداً لوجود توني بلير فيه، إذ لا يوثق به في بريطانيا نفسها ولا يمكن أن يُعهد إليه بأي مهمة.
5) قضية إعادة الإعمار والاستثمار فيها مرشحة لإحداث الكثير من البلبلة بين الدول المعنية أو الراغبة، فالأرجح أن ترمب يعتبر «مجلس السلام» بمثابة «مجلس لإدارة الإعمار»، وهو يريد أن تكون لإسرائيل «حصة» في الورشة، كما أنه لم يُفصح ولم يُنقَل عنه أنه يدعم المشروع الذي أعدّته مصر وحظي بتأييد عربي – إسلامي، فضلاً عن تأييد الأوروبيين الذين يستشعرون استبعاداً لدورهم.
في أي حال، كان ترمب صريحاً وواضحاً في أنه وضع خطته على خلفية التوسّع في «الاتفاقات الإبراهيمية» التي بدأها قبل أن تصبح إسرائيل على ما هي عليه اليوم من عزلة ونبذ دوليين، ويحتاج تحسين سمعتها وصورتها إلى أكثر مما تقترحه «خطة ترمب» التي تحقّق عملياً أهداف حربها.
كما أن هدف «السلام الدائم» يتطلّب الانتقال إلى مسار ديبلوماسي جديد مع إيران، فمع انتهاء صلاحية الاتفاق النووي (2015) لم تعد هناك «رسمياً» أي قيود مفروضة على برنامجها الذي تعرّض لأضرار جسيمة لكن غير قاتلة. لا شك أن معاودة واشنطن وإسرائيل طرح حلول ناقصة وغير عادلة للقضية الفلسطينية، أو منتهكة لسيادة لبنان وسوريا، ستترك الكثير من الثغرات أمام إيران لإنعاش دورها في المنطقة.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»