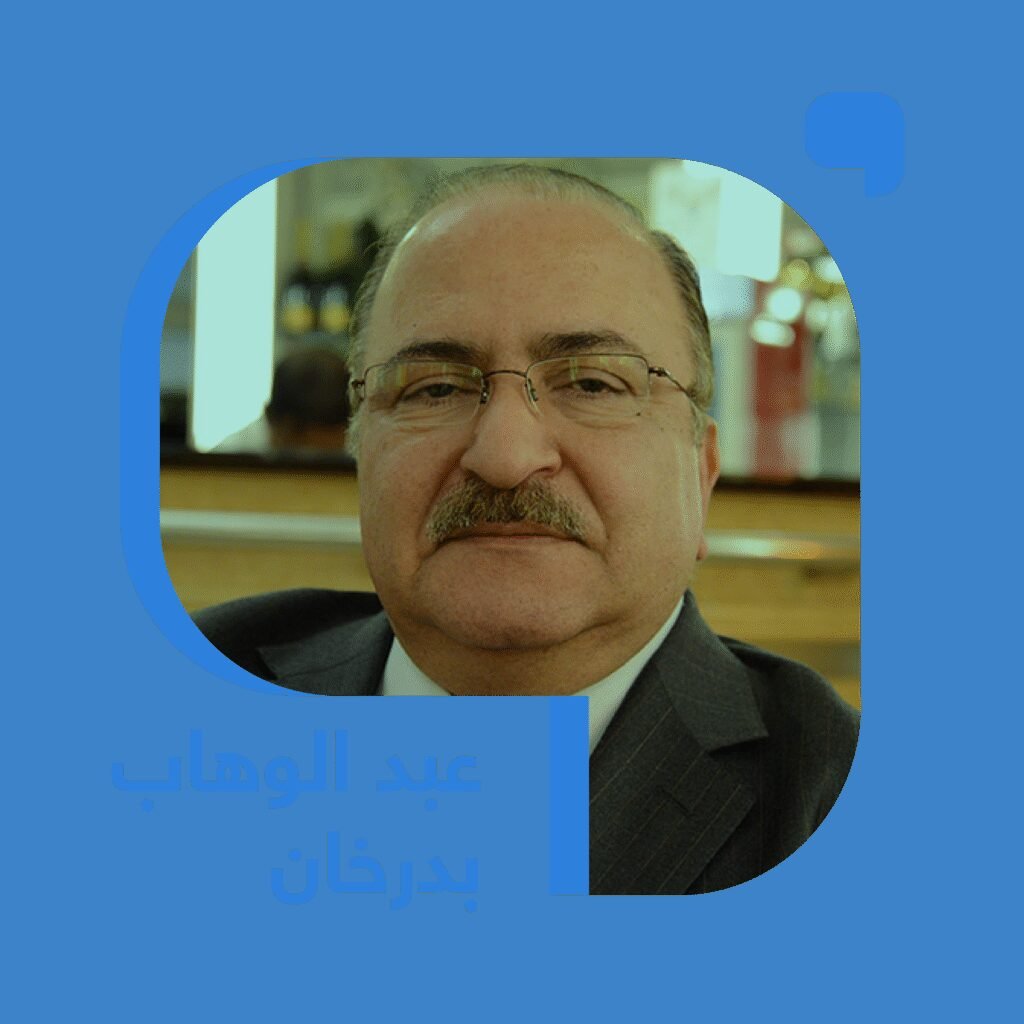
وفجأة شنّت «حماس» وفصائل غزّة هجوم «السابع من أكتوبر» 2023، وردّت إسرائيل بالحرب التي استمرّت عامين زائد يوم، وفي هذا اليوم أمكن التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب. لكن، قبل ذلك، كانت القضية الفلسطينية عادت ففرضت نفسها في شوارع العالم وعلى الديبلوماسية الدولية، وشكّل «تسونامي» الاعترافات بـ«دولة فلسطين» ضغطاً على الإدارة الأميركية وزاد من عزلتها مع إسرائيل، فأدركت واشنطن أنه لم يعد مجدياً الاستمرار في تغطية الكوارث في غزة. وهكذا ولدت «خطة ترامب» لإنهاء الحرب.
والآن، ترتفع الأصوات، عربياً وإسلامياً وغربياً، مطالبةً بأن يُتّخذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى كأساس يُبنى عليه لإقامة «سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائم». في اليوم التالي للاتفاق عقد اجتماع وزاري (أوروبي- عربي) في باريس للبحث في «اليوم التالي في غزّة»، واعتبر أن «خطّة ترامب» باتت تمثّل مع وقف إطلاق النار «فرصة تاريخية» ينبغي تفعيلها من أجل «سلام مستدام». قال الرئيس الفرنسي إن هدف الاجتماع هو «عملٌ مواز» للخطة الأميركية و«مكمّلٌ» لها، وكان وزير الخارجية الأميركي مدعواً لكنه ألغى مشاركته، ولم تُدعَ إسرائيل. استشعرت واشنطن أن الأوروبيين يسعون إلى دفع «خطة ترامب» في اتجاه لم يُخَطَّط له، خصوصاً أن مداولات اجتماع باريس تمحورت حول «حلّ الدولتين» وكانت فيها التفاتة إلى الوضع في الضفة الغربية، وكيف أن مشروع «الدولة» الموعودة مهدّدٌ بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين وازدياد النبذ الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية، كما أن الدول الممثلة في باريس تحبّذ شرعنة «خطة ترامب» وأي مساهمة عربية ودولية فيها عبر مجلس الأمن، لكن واشنطن أظهرت نية واضحة في نبذ الأمم المتحدة.
كان دخول الحرب في مسارات الإبادة والتجويع والتوسّع في الاحتلال تمهيداً لتهجير السكان وراء الانقلاب الغربي على إسرائيل. ومن الواضح أن الإشادات بالرئيس الأميركي، الذي أعلن شخصياً نهاية الحرب، لم تخفِ مخاوف الأوساط الدولية من معاودة إبقاء ملف الصراع في دائرة أميركية- إسرائيلية مغلقة، كما كان طوال ثلاثة عقود عقيمة تخللها الكثير من التغاضي الأميركي عن مطامع إسرائيل والتماهي مع خطط المتطرّفين في حكوماتها، إلى أن دخلت إيران على الخط وساهمت في التحضير لـ «طوفان الأقصى» الذي تلقفته إسرائيل وأدارت ما بعده بطريقتها ولا تزال تطمح إلى استغلاله في اتجاهَين: إنهاء القضية الفلسطينية، واستخدام تفوّقها العسكري لفرض مشروع «إسرائيل الكبرى». وليس واضحاً ما إذا كانت لدى ترامب إرادة (أو رغبة وقدرة) لـ «إصلاح» السلوك العسكري والسياسي والأخلاقي لإسرائيل، فهذا لا بدّ أن يمرّ بالضرورة- إذا كان ممكناً تصوّره- بـ «إصلاح» المقاربة الأميركية للشرق الأوسط. عملياً، ليس إصلاح السلطة الفلسطينية وحده المطلوب.
أمكن التوصّل إلى «اتفاق شرم الشيخ» في يومين، بعد فشل دام شهوراً من المفاوضات. أطلق ترامب تهديدات كثيرة لـ «حماس» لم يكن مضطراً لها لأن الحركة أصبحت، بعد التغطية العربية – الإسلامية لنزع سلاحها وتفكيك حكمها، في صدد القبول بأي شيء من أجل إنهاء الحرب. وفي الوقت نفسه مارس ترامب ضغوطاً على إسرائيل، بما فيها توبيخٌ لنتنياهو الذي حاول أن يعامله بالأكاذيب كما تعامل سلفه جو بايدن. لكنه سيدرك عاجلاً أو آجلاً أن إنهاء الحرب في غزّة لا يزال قيد الإنجاز، ولا يشكل بعد مشروعاً للسلام في المنطقة.
تكمن الصعوبة في المهمة الأكبر، تحديداً في اقتناع أميركا ثم في إقناعها إسرائيل بأن أمنها مرتبط عضوياً بقبول الشعب الفلسطيني والتعايش معه، وليس باستدامة احتلال أرضه والتحكّم بمصيره والسعي إلى «إبادته»، ولا بمحاولة الهيمنة على المنطقة العربية. وإذا كان إضعاف المشروع الإيراني وإقصاؤه أزالا عقبة أمام سلامٍ ممكنٍ في المنطقة، فإن أميركا والقوى الغربية تجد نفسها اليوم مضطرّة لمراجعة «الوظيفة» التي كانت اعتمدتها لإسرائيل، وللاعتراف بأن إسرائيل مسؤولة عن إحباط كل مشاريع السلام السابقة، حتى أنها فشلت في فهم المتغيّرات العربية الماثلة أمامها معتقدةً بإمكان إخضاعها لمشاريعها التوراتية.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»